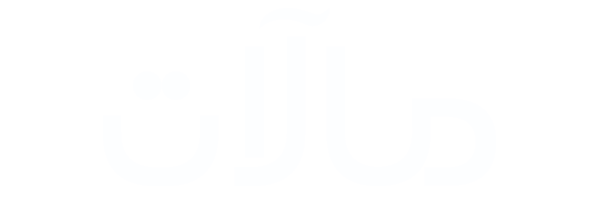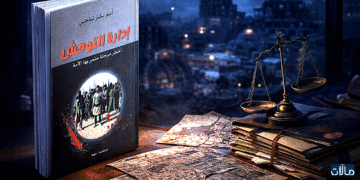مقالة حبيسة في الأدراج
في زاوية من مكتب الإعلامي والأديب “نعيم مصطفى“، يتربص نص غير منشور، وكأنّ روحه الحبيسة تنتظر من يفرج عنها. هذا النص الذي يبدو أنه قد شغل الكاتب لفترات طويلة، يدعونا إلى “التجول” بين سطوره، و”التدقيق” في مصطلحات سياسية أصبحت بالية لا بد من تحديثها : ديكتاتورية – استبداد – طغيان.
ففي عالم السياسة اليوم، كثيرٌ من المصطلحات التي كانت في يومٍ ما تحمل زخماً فكرياً وتأثيراً عملياً، أصبحت مجرد كلمات مفرغة من معناها، تهالكت بفعل الزمن وأصبحت غير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة التي تطرأ على الساحة. وكأنها جثث لغوية تنتظر من يدفنها أو يبعث فيها روحاً جديدة. هذه المصطلحات التي كانت تمثل في الماضي قضايا وأفكاراً حية تتداولها المجالس والمناقشات، أصبحت اليوم خارج سياق المعاصرة، عاجزة عن التعبير عن الواقع السياسي المتحول.
أستميحك عذراً يا نعيم
إن المقالة، بوصفها كائناً معرفياً حياً، لا يجوز دفنها في أركان المكاتب، بل يجب أن تبقى نابضة بالحياة، تعيد التفكير وتطرح تساؤلات جديدة. وبين يديّ اليوم نص الذي لم تنشره بعد، يتضمن ما يثير فضول القارئ ويدعوه إلى التأمل في تلك المصطلحات السياسية البالية. هل هي أفكار متكاملة تنتظر التحرير، أم مجرد بقايا لمفاهيم فقدت بريقها؟ فكما يتوق الباحثون إلى اكتشاف مخطوطات قديمة، كنت أبحث عن قيمة جديدة داخل تلك الكلمات التي باتت حبيسة الزوايا.
وعلى صفحات “مآلات”، حان الوقت لعصرنة هذه المصطلحات، والبحث في معانيها العميقة:”ديكتاتورية”، “استبداد”، “طغيان”، وغيرها.
مصطلحات سياسية لا بد من تحريرها: ديكتاتورية – استبداد – طغيان
بقلم: “نعيم مصطفى“
تشهد الساحة الدولية والإقليمية صراعات سياسية وعسكرية، لم يسبق أن شهدتها منذ زمن بعيد -أيام “فيديل كاسترو“- حتى قيل -آنذاك مثلما يقال اليوم- إننا نوشك أن نكون على حافة الحرب العالمية الثالثة .
اليوم، سورية ولبنان منفجرين والعراق لم تخمد نار التحولات التي طرأت عليه، واليمن -الذراع الإيراني- على صفيح ساخن. وليبيا بين الهدوء تارة والتوتر طوراً، وإيران تتأهب لتشهد ضرب إسرائيل مفاعلاتها النووية، وفي أفغانستان جمر تحت الرماد لم تنطفئ بعد، و… و…
ولو عدنا إلى الجذور والأسباب وراء تلك الصراعات، لوجدنا أنها تكاد تنحصر في تمكن القوى الصهيونية أنْ تبسط ذراعها بعد انصياع الزعماء العرب لسطوتها. وكما جرت العادة، نربط كل شيء بعوامل خارجية مختلفة، أو بنظرية المؤامرة التي أصبحت موضة العصر، متجاهلين نسبها أيضاً إلى العطالة العربية وتماهيها. فعندما يشيع التناغم الحقيقي، غير المزَّيف بين القاعدة والهرم. وبين الراعي والرعية ، فحينئذ توصد الأبواب أمام الطامعين والمستعمرين.
وفي رأيي أن الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، هم وراء تلك الصراعات ووراء التخلف، ووراء تموضع الدول ذات الصلة في ذيل الأمم، فهل رأينا دولة أوربية يتصارع شعبها مع بعضه البعض، من أجل الحفاظ على الكرسي فحسب؟
إنَّ الديمقراطية كفيلة بحقن الدماء، وشيوع التطور والرفاهية، في أي دولة أو مكان في العالم.
وبناءً على ما تقدَّم أشرع في الوقوف عند تلك المصطلحات التي عنونت بحثي بها:
1- الديكتاتورية:
إنَّ مصطلح الديكتاتورية في الاستخدام الحديث، يعني النظام الحكومي الذي يتولى فيه شخص واحد جميع السلطات وبأداء شمولي. وفي الأعم الأغلب بطريقة غير مشروعة، ويملي أوامره وقراراته السياسية، ولا يكون أمام بقية المواطنين سوى الخضوع والطاعة. وهذا المصطلح لا يكاد يتميز عن مصطلح الاستبداد.
يقول الدكتور عبد الحميد البكوش:
“عندما نقرأ تاريخ الإنسان السياسي، أن حكم الفرد نقيض للحرية، وأنَّ كفاح الشعوب من أجل الحرية، كان على الدوام كفاحها للحد من سلطة الحكام.”
فأي اتساع لمجال سلطة الحكم، هو بالقطع انتقاص من مساحة حرية الناس، وحسم من حسابهم، وعليهم ألا يلوموا أنفسهم على أي انتقاص من حرياتهم.
إنَّ معرفتنا لنوازع البشر غير الملائكية، يجب أن تجعلنا ندرك أن أي إنسان تسمح له فرصة الانفراد بالسلطة لن يضيعها إلا فيما ندر. وهو لا بد له من أن يحرص على البقاء، فور أن يتذوق حلاوة الجلوس في القمة منفرداً.
إذا كانت هذه الحقيقة البشرية لا تبرر أي حق لأي ديكتاتور في أية سلطة، إلا أنها تفسِّر وتشرح ميل الفرد إلى الاستبداد. ورغم وجود المرشحين للدكتاتورية في شعب ما، فإنها لا تقوم إلا إذا توفر الشرط الثاني. وهو استعداد الشعب للانقسام، بين حماة المستبد وضحايا لممارساته.
2- الطاغية:
رجل يصل إلى الحكم بطريق غير مشروعة، فيمكن أن يكون قد اغتصب الحكم بالمؤامرات أو الاغتيالات، أو القهر أو الغلبة بطريقة ما. وباختصار: هو شخص لم يكن من حقه أن يحكم ، لو سارت الأمور سيراً طبيعياً ، لكنه قفز إلى منصة الحكم عن طريق غير شرعي.
لهذا يتحكم “الرئيس الفرد الصمد” في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب والمعتدي. كما يضع كعب رجله في أفواه ملايين الناس لسدها ليحبس النطق بالحق.
يقول الملك جيمس في خطاب أمام البرلمان الإنجليزي سنة 1630:
“إنَّ الفرق بين الملك والطاغية، هو أن الأول يجعل من القوانين حداً تنتهي عنده سلطته، كما أنه يجعل من خير المجموع الغرض الأساسي لحكمه. أما الطاغية فلا حدّ لسلطانه، كما أنه يسخر كلَّ شيء لإرادته ورغباته”. وإن كان من الممكن الجمع بين هاتين الخاصتين في خاصية واحدة، فهي عدم المساءلة، فهو لا يسأل عما يفعل وهم الذين يُسألون!
وإذا كان طغاة اليونان كانوا لا يشبعون شهواتهم ومصالحهم الخاصة، فقد تكون شهوات طغاة اليوم أوسع وأعمق لتكوين إمبراطورية، أو إقامة أمجاد زائفة لأنفسهم، أو إعادة فكرة تاريخية عفا عليها الزمان!
والطاغية يظهر لإنقاذ الجماهير، وهو يتولى الحكم بدعوى رفع الظلم الواقع عليها، ويلجأ إلى إشاعة الفوضى والبلبلة والاضطراب حتى يُشعِر الجماهير بحاجتها إليه، وحمايتها من طبقة الأغنياء التي تستولي على حقوقها !
يقول جون لوك معرفاً الطغيان:
إذا كان الاغتصاب هو ممارسة إنسان ما لسلطة ليست من حقه ، فإنَّ الطغيان هو ممارسة سلطة لا تستند إلى حق ، ويستحيل أن تكون حقاً لإنسان ما.
3- الاستبداد:
ظهر مصطلح المستبد لأول مرة إبان الحرب الفارسية الهلينية في القرن الخامس ق.م. وكان أرسطو هو الذي طوَّره وقابل بينه وبين الطغيان، وقال:
“إنهما ضربان من الحكم ، يعاملان الرعايا على أنهم عبيد”.
لكن ظهور مصطلح الاستبداد في قاموس الفكر السياسي، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يرجع إلى مونتسكيو (1689-1755) الذي جعل الاستبداد أحد الأشكال الثلاثة للحكم، إلى جانب الجمهورية والملكية. لقد دان الرق والاستعباد بصورة حاسمة. وينتهي إلى أن الاستبداد نظام طبيعي، بالنسبة إلى الشرق، لكنه غريب وخطر على الغرب.
“… والاستبداد ظاهرة تعويضية، إذ تتوافر في الشخصية المستبدة بشكل عام، في الأشخاص فاقدي الثقة بأنفسهم، الذين لم ينجحوا قط في تكوين شخصياتهم تكويناً متكاملاً مستقراً، يدفعهم النقص الذي يعرفونه من أنفسهم إلى محاولة تعويضية في العالم الخارجي. فهم عندما يستعملون العنف ضد أية محاولة لتغيير اجتماعي، بحجة الدفاع عن استقرار النظام القائم. يدافعون في الحقيقة عن ذواتهم، التي تفتقد الاستقرار النفسي. ويؤدي هذا كله إلى نزوع عدوان مختلط بالحقد، على كل من لا يوافقهم في الرأي أو يتميز عنهم”.
كذلك، فإنَّ الاستبداد يفعل فعله، في إفساد وجدان الفرد وانحطاط أخلاقه، وتعطيل طموحه، وبالتالي الحط من إنسانيته.
فقد قال المنفلوطي توضيحاً لذلك :
” لا، ليست جناية المستبد على أسيره أنه سلبه حريته ، بل جنايته الكبرى عليه أنه أفسد عليه وجدانه ، فأصبح لا يحزن لفقد تلك الحرية ، ولا يذرف دمعة واحدة عليها.”
وتعبيراً منه عن دور الاستبداد في الانحدار بآدمية الإنسان، قال لطفي السيد:
“إنَّ الاستبداد المستمر طويلاً، يهدم الكائن البشري ، لأنه يحول دون أن تكون الطبيعة الخلقية على أتمها. وبكلمة أنه يجعل من الإنسان أقل من الإنسان.” … على أن تأثير الاستبداد لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل إنه يقود إلى انحطاط الأمم وتخلفها أيضاً.”
ويقول المفكر السياسي الكبير عبد الرحمن الكواكبي:
“وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي، من طلب الترقي إلى طلب التسفّل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت، وإذا ألزمت بالحرية تشقى، وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراحها. وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق ، يطيب له المقام على امتصاص دم الأم ، فلا ينفك عنها حتى يموت”.
أما عبد الله النديم فقد عقد مقارنة بين تقدُّم الغرب وتأخر الشرق، فتبين له أن الديمقراطية هي سبب الحاجة الأولى، بينما الاستبداد سبب الثانية. يقول النديم:
“خذ ممالك أوربا بنظام المجالس وتحميلها المسؤولية للنواب والوزراء الخاضعين للقانون ونظام الشورى. وبالمقابل فإن تضييق الملوك الشرقيين على رعاياهم والاستبداد بهم من أسباب تأخر الشرق.”
تُعبّر مقولة النديم، هذه، عن إعجابه بالنموذج البرلماني الغربي، خاصة نظام المجالس النيابية وتوزيع المسؤولية بين النواب والوزراء. يرى النديم أن هذا النظام، القائم على مبدأ سيادة القانون والشورى، هو نظام مثالي يمكن أن يُطبق على أي دولة، حتى لو كانت في منطقة مختلفة كأوروبا.
وختاماً
بعد أن عرضت لتحرير تلك المصطلحات الشائعة في عصرنا، لابد لي من إسقاطها على الزعماء الذين يتلبسون بتلك الصفات في عصرنا الحديث. إننا نجد على رأس أولئك الزعماء، بل المجرمين المارقين ما يُسمى بالرئيس “بشار الأسد” بلا منازع، ثم يليه الطاغية “معمر القذافي“. وكذلك لا يستثنى المخلوع “علي عبدالله صالح“، والرئيس الفار “زين العابدين“، ولا ننسى نهاية “حسني مبارك” … وكثيرون من أمثالهم يقبعون فوق رؤوس شعوبهم حتى اليوم. السيرة الذاتية لأولئك الفراعنة النرجسيين الساديين، لا تحتاج إلى شرح وتفصيل، وإنما يعرفها الصغير والكبير معاً.