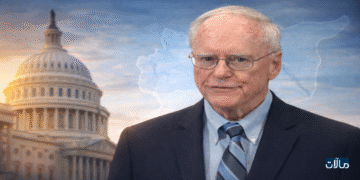بادئة:
منذ اندلاع الثورة السورية، ظل سؤال الانتقال السياسي سؤالاً معلّقاً على مفترق طرق تتنازعه قراءات متعددة. ومع بروز سلطة أحمد الشرع الانتقالية، برز مجدداً النقاش حول ما إذا كان هذا المسار يمثل نقطة تحوّل نحو دولة وطنية مدنية ديمقراطية ليبرالية، أم أنه لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لنمط السلطة الأحادية. ولعل مداخلة العميد مناف طلاس في باريس، حين أشار إلى أن الشرع “دخل إلى السلطة ولم يدخل إلى الدولة“.
تكثّف هذه الجملة جوهر المعضلة البنيوية السورية: الفصل بين السلطة كأداة حكم، والدولة كإطار كيان سياسي جامع.
ومن هنا أتناول الإطار المفاهيمي: بين “ويبر ولينز” و “كازانوفا” للمقاربة الفكرية، حيث يمكن تلمّس ثلاث زوايا تحليلية:
- نظرية الدولة الحديثة عند “ماكس فيبر“، التي تحدد الدولة بقدرتها على احتكار العنف الشرعي ضمن إقليم محدد، وبما تملكه من مؤسسات بيروقراطية تتجاوز الأفراد. في سوريا، لم يتحقق هذا الشرط تاريخياً إلا جزئياً، وهو اليوم في حالة تفكك شديد.
- نظريات الانتقال الديمقراطي كما قدّمها “خوان لينز” و “ألفريد ستيبان“، حيث يُشدد على التوافق النخبوي، وبناء مؤسسات ضامنة، والتحول التدريجي من منطق السلطة الفردية إلى دولة القانون. هذه المقاربة توضح كيف أن أي انتقال لا يستند إلى توافق نخبوي حقيقي يظل هشاً وعرضة للنكوص.
- العلاقة بين الدين والسياسة وفق أطروحات “خوسيه كازانوفا“، الذي ميّز بين الحضور القيمي للدين في المجال العام وبين تحوله إلى سلطة سياسية. وفي الحالة السورية، يمكن للإسلام الشامي المعتدل أن يؤدي دور “الشرعية القيمية” لا “الشرعية السلطوية“.
سُلطَةٌ بلا دولة!
في ظل هذه الأطر النظرية، يتضح أن سلطة الواقع الانتقالية الراهنة تمثل نموذجاً لإشكالية “السلطة بلا دولة“. فهي لم تنجح في ترجمة الانتقال السياسي إلى عملية تأسيسية لبناء المؤسسات، بل تمحورت حول إعادة إنتاج منطق السيطرة بآليات جديدة. هذا يعيد إلى الأذهان ما صاغه “غييرمو أودونيل” بمفهوم “الديمقراطية المعيبة“، حيث تتحول الديمقراطية إلى واجهة شكلية، بينما تبقى جوهر السلطة محتكرة.
يشدد “صامويل هنتنغتون” في “الموجة الثالثة” على أن أي عملية تحول ديمقراطي لا تُكتب لها الاستمرارية ما لم تنخرط فيها قوى المجتمع على نطاق واسع. في الحالة السورية، فإن غياب التشاركية يعيد إنتاج الاستبداد بأشكال جديدة، ويفرغ أي عملية انتقالية من مضمونها التأسيسي، ومن نافلة القول: (أنّض التشاركية ركبية التحول لا هامشه).
المقاربة السورية لمسألة الدين والدولة يجب أن تنطلق من مبدأ الحياد المؤسسي لا الإقصاء القسري. فالدين، وخصوصاً في نسخته الشامية الوسطية، كان عبر التاريخ مكوّناً من مكونات التوازن القيمي للمجتمع، لكنه لم يكن قاعدة للحكم السياسي المباشر. استعادة هذا الدور التاريخي يمكن أن يحفظ الاستقرار الروحي من دون أن يهدد حيادية الدولة.
“لا يمثل الإسلام الشامي المعتدل مجرد مذهب فقهي، بل هو نمط ثقافي واجتماعي قائم على التعددية، حيث يتعايش المسلمون مع الأقليات الأخرى بروح من القبول والاحترام المتبادل.”
ومن مندوحة القول، لا يُمكن تَصوّر عملية انتقال حقيقية في سوريا من دون إعادة تأسيس لمؤسسة عسكرية وطنية لا إعادة التوظيف، علمانية التوجه، محايدة سياسياً، وقادرة على ضمان وحدة البلاد. وكما بيّن “هنتنغتون” في “الجندي والدولة“، فإن الجيوش في الدول الحديثة لا تقوم على الولاءات الضيقة، بل على المهنية والالتزام بالقانون. هذا الشرط يمثل صمام الأمان لأي تحول ديمقراطي ليبرالي مدني.
عند دراسة المشهد السوري، يتضح أن أبرز العقبات التي تعترض عملية الانتقال تكمن في:
- سيادة منطق السلطة على حساب بناء مؤسسات الدولة.
- تدهور الثقة المجتمعية بفعل ممارسات الاستبداد والإقصاء.
- انعدام التعددية السياسية وغياب المشروع الوطني الجامع.
- تأثير التدخلات الخارجية السلبية.
- توتر العلاقة بين الدين والسياسة في المجتمع.
- غياب مؤسسة عسكرية وطنية وموحدة.
الخلاصة: نحو عقد اجتماعي جديد
إن جوهر المأساة السورية ليس في من يمسك بزمام الحكم، بل في غياب رؤية وطنية جامعة لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. فالمأزق السوري كله يختزل في الخلط بين الدخول إلى السلطة والدخول إلى الدولة. ولهذا، لن يحل الأزمة مجرد تغيير الوجوه، بل يجب أن يكون الحل في إعادة تأسيس الدولة على ركائز المشاركة، والحياد المؤسسي، وعقد اجتماعي جديد.
إن مسار التحول الديمقراطي يتطلب تجاوزاً كاملاً للاستئثار لصالح التشاركية، وإعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة كحضور قيمي بعيداً عن السياسة، وتأسيس مؤسسة عسكرية وطنية علمانية تضمن المسار المدني. بهذه المعادلة وحدها، يمكن لسوريا أن تثبت أن الدولة هي الإطار الذي يحتضن الجميع ويتجاوز السلطة، وأن الوطن هو ما يوحد أبناءه لا ما يفرقهم.