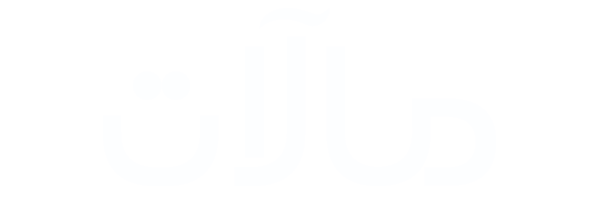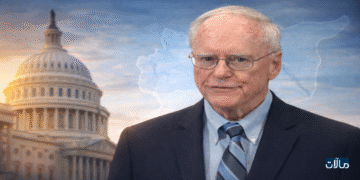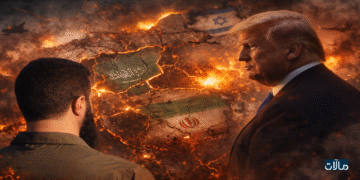المقدمة: بين التغوّل الاستيطاني وواقع “إسرائيل الكبرى” المتسارع
يمثل المشهد الدبلوماسي الراهن منعطفاً حاداً في سجل إسرائيل الدولي، حيث واجهت تل أبيب سلسلة من النكسات القانونية والدبلوماسية غير المسبوقة في فترة زمنية وجيزة. فبعد تجاوزات عسكرية مست الردع الإقليمي، جاءت الإدانة الصريحة من مجلس الأمن الدولي لضربة استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة، وهو بيان أُصدر بإجماع نادر بين الأعضاء، مما عكس غضباً جماعياً واضحاً على الرغم من جهود واشنطن للحيلولة دون الإشارة إلى إسرائيل بالاسم. وقد تبع ذلك، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، بلغت 142 دولة من أصل 164، لصالح مبادرة إقامة دولة فلسطينية.
التحولات في السياسة الدولية
إن هذه السلسلة من الإدانات والقرارات ليست مجرد خلافات سياسية عابرة، بل تعكس تحولاً هيكلياً في البيئة الدولية المحيطة بالصراع. والمفارقة الصارخة هي أن إسرائيل، في خضم هذه العزلة المتفاقمة، اختارت استراتيجية “الهروب إلى الأمام“، عبر تسريع خطواتها نحو تحقيق حلمها الأيديولوجي المتطرف: أسطرة مفهوم “أرض إسرائيل الكبرى“. يتمثل هذا التناقض الجوهري في أن اللحظة التي تزداد فيها ملاحقة إسرائيل قانونياً وتآكل مظلة حمايتها الدبلوماسية، هي ذاتها اللحظة التي يُسارع فيها اليمين الإسرائيلي المتطرف بفرض وقائع الضم والاستيطان على الأرض بعناد يتجاهل التداعيات الدولية.
العدم سمة الجمعية العامة
تكمن الأهمية الحقيقية لتصويتات الجمعية العامة الأخيرة، بالرغم من طبيعتها غير الملزمة، في الكشف الواضح عن تفاقم عزلة إسرائيل الدبلوماسية، لدرجة أن بعض المدافعين عنها منذ فترة طويلة قد تخلوا عنها مؤخراً. وتشير التحولات الأخيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترى أن الاستثمار الأيديولوجي في فرض مشروع “إسرائيل الكبرى” يوفر “شرعية داخلية” تعوض عن الخسارة المتسارعة “للشرعية الدولية“، عبر المراهنة على أن الضم سيكون أمراً واقعاً لا يمكن عكسه. يهدف هذا التقرير إلى الكشف عن أبعاد هذا التناقض، وتحليل تفكك الدعم الدولي لإسرائيل، ورصد الأدوات القانونية والاقتصادية التي تتشكل لمواجهة مشروع التغوّل الإسرائيلي.
المحور الأول: ميزان القوى الدبلوماسية: تحوّل الأمم المتحدة وتفكك “الدعم السلبي”
سقوط القناع الغربي: 15 دولة تحوّل الامتناع إلى إدانة
يشكل نمط التصويتات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مدار السنوات القليلة الماضية، بوصلة واضحة لتحول المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، بعيداً عن الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في تهميشها. وبتحليل أنماط التصويت على ثلاثة قرارات محورية (2017 بشأن القدس، 2023 بشأن وقف إطلاق النار، والتصويت الأخير لتأييد الدولة الفلسطينية)، يتضح الاتجاه المقلق للعزلة الإسرائيلية.
إن الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول تكمن في انخفاض عدد حالات الامتناع عن التصويت. ففي العرف الدبلوماسي للجمعية العامة، يُعتبر الامتناع عن التصويت نوعاً من أنواع “الدعم السلبي” لإسرائيل، حيث يتيح للدول تجنب الإدانة الصريحة مع عدم معارضة إسرائيل علناً. إن انخفاض هذا العدد يمثل خسارة صريحة للغطاء الدبلوماسي الذي كانت إسرائيل تتمتع به. ورغم أن مجموعة “المعارضين” تبدو متماسكة في ظاهرها، إلا أنها كشفت عن تقلب واضح، ولم تُعارض كافة القرارات الثلاثة سوى دولتين صغيرتين بجانب الولايات المتحدة و إسرائيل هما ميكرونيسيا و ناورو.
انشقاق الدائرة الغربية: فقدان الخمسة عشر حليفاً
إن التدهور في الدعم السلبي أصبح خطيراً بشكل خاص بين الدول ذات التوجه الغربي، ولا سيما داخل الاتحاد الأوروبي والكتلة الأنجلوسكسونية. فبينما كانت ثماني دول أعضاء أو مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي تمتنع عن التصويت في عام 2017، وارتفع العدد إلى إحدى عشرة دولة في عام 2023، انخفض هذا العدد بشكل كبير في التصويت الأخير، حيث لم تمتنع سوى دولتين فقط (جمهورية التشيك ومولدوفا)، فيما اعترضت المجر.
مواقف دوليّة مُستجدّة
تكشف الأرقام عن أن إسرائيل فقدت الدعم السلبي لدى خمس عشرة دولة ذات توجه غربي كانت قد امتنعت عن التصويت في القرارات السابقة، ومن أبرزها: أستراليا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا. لم يعد هذا التحول مجرد مسألة تصويتات شكلية، بل يعكس تغيرات سياسية داخلية عميقة. بالنسبة لهذه الدول، لم يعد الامتناع خياراً “مريحاً” دبلوماسياً؛ فقد أصبح الامتناع عن التصويت بحد ذاته يُكلف الحكومات سياسياً داخلياً، خاصة مع تزايد الغضب الشعبي الغربي، مما أجبر هذه الدول على التصويت مع الأغلبية العالمية لامتصاص هذا الغضب والحفاظ على سمعتها الدولية. هذا التطور يرفع بشكل مباشر الكلفة الدبلوماسية لأي عملية إسرائيلية مستقبلية.
يُظهر المشهد الدولي الجديد انقساماً لافتاً في أوروبا؛ فمن بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المملكة المتحدة، أيد النصف تقريباً كافة القرارات الثلاثة، وهي دول مثل بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، الدنمارك، واليونان.
دور الرأي العام الأوروبي كقوة ضغط محورية
إن التغير الملحوظ في مواقف الحكومات الأوروبية لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والضغط الداخلي الهائل من الرأي العام والمظاهرات المؤيدة لفلسطين في العواصم الكبرى. فقد تحولت مواقف أغلب الحكومات الأوروبية بشكل لافت، مما طرح فكرة مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وقد أشارت تقارير إلى أن هذا التغيير غير المسبوق من أوروبا جاء نتيجة “الضغط في الداخل الأوروبي على الحكومات، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل“. فمنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، ظهر تباين واضح بين المواقف الرسمية الأولية الداعمة لإسرائيل والمواقف الشعبية التي طالبت بوقف إطلاق النار وحق سكان غزة في الحياة، مما دفع مئات الآلاف للتظاهر في لندن وباريس ومدريد. هذا التحول يؤكد أن قوة الرأي العام الأوروبي قد أصبحت عاملاً حاسماً في صياغة السياسات الخارجية للدول الأعضاء، مما يجعل الدعم السلبي لإسرائيل غير قابل للاستدامة سياسياً.
جدول يُبيّن انحسار “الدعم السلبي” الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
| القرار/السنة | قرار 2017 (نقل السفارة للقدس) | قرار 2023 (وقف فوري لإطلاق النار) | قرار الأسبوع الماضي (تأييد الدولة الفلسطينية) | دلالة التحول |
| عدد حالات الامتناع | مرتفع (شمل 8 دول مرشحة/أعضاء بالاتحاد الأوروبي) | متوسط (11 دولة من الاتحاد الأوروبي، اعتراض دولتين) | منخفض جداً (2 فقط: التشيك ومولدوفا، واعتراض المجر) | تآكل مساحة المناورة الدبلوماسية، وتحول صريح لـ 15 دولة غربية من الامتناع إلى التأييد. |
| عدد المؤيدين (تقريباً) | 128 | 153 | 142 | اتساع الكتلة المؤيدة لفلسطين في القضايا الجوهرية. |
| أبرز الدول الغربية التي تحوّلت من الامتناع إلى التأييد | أستراليا، كندا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، أوكرانيا. | – | – | خسارة الدعم السلبي لخمس عشرة دولة ذات توجه غربي |
المحور الثاني: الجبهة القانونية: من الحصانة السياسية إلى ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية
مطاردة القادة: كيف حوّلت العدالة الدولية الحصانة إلى مذكرات توقيف
تتصاعد جبهة الملاحقة القانونية ضد إسرائيل، التي لم تعد تقتصر على الإدانة السياسية، بل تجاوزتها إلى المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة. ويتمثل الخطر المزدوج في عمل محكمة العدل الدولية (ICJ)، التي تنظر في مسؤولية الدول، والمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، التي تنظر في مسؤولية الأفراد عن جرائم الحرب.
فيما يتعلق بمسؤولية الدولة، تتابع تركيا عن كثب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وقد قررت تركيا التدخل في القضية وقدمت بيان التدخل الرسمي في أغسطس 2024، مؤكدة أهمية حل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة. إن التدخل التركي ليس مجرد موقف أخلاقي، بل هو تحرك جيوسياسي إقليمي يستخدم القانون الدولي كأداة ضغط فعالة، مما يعزز عزلة إسرائيل ويشجع دولاً أخرى على استخدام الأدوات القانونية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، مشددة على ضرورة وقف النشاط الاستيطاني وإنهاء الاحتلال “غير القانوني“.
أما على صعيد المسؤولية الجنائية الفردية، فقد شكلت أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في نوفمبر 2024، ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، سابقة تاريخية. وقد صدرت أوامر الاعتقال بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إن هذه الخطوة غير المسبوقة تنزع صفة الحصانة عن القيادة السياسية والعسكرية، وتحول الصراع من خلاف سياسي إلى مسألة ملاحقة جنائية دولية، مما يعيق حركة القادة المستهدفين ويزيد من عزلتهم الدولية. بينما تصف إسرائيل هذه الملاحقات بأنها “معادية للسامية” أو “مسيسة“، فإن الإجراءات القانونية تستند إلى أدلة قوية كافية لتسويغ إصدار المذكرات، مما يدل على فشل إسرائيل في الاعتماد على الحصانة السياسية الأمريكية حصرياً.
الضغط على شراكة الاتحاد الأوروبي والأثر الاقتصادي
تتضاعف الأزمة الدبلوماسية والقانونية مع تلويح الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وتنص الاتفاقية بوضوح على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية لها. ومع تصاعد انتهاكات القانون الدولي، بات هناك ضغط من منظمات حقوق الإنسان على الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية، معتبرين أن رفض التعليق في ظل استمرار الانتهاكات يمثل “خيانة قاسية وغير مشروعة“
ويمثل التهديد بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية وحركة المقاطعة الاقتصادية (BDS) ضغطاً اقتصادياً ملموساً يتجاوز الإدانة اللفظية. فخسارة هذه الاتفاقية تعني تأثيراً كبيراً على الصادرات الإسرائيلية. وقد أدت حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات إلى إقدام شركات كبرى مثل فيوليا (Veolia) و أورانج (Orange) على إنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية، وهو ما أكد خبراء الأمم المتحدة والبنك الدولي أنه يسبب أثراً اقتصادياً على إسرائيل. وتتقاطع هذه الأدوات القانونية والاقتصادية لتؤكد تزايد عزلة إسرائيل الاقتصادية التي أقر بها رئيس وزرائها.
جدول يُعدد الجبهات القانونية الدولية ضد إسرائيل (ICC و ICJ)
| الجهة القانونية | القضية الرئيسية | الحالة الجنائية / المدنية | التهم الموجهة (أبرزها) | الأثر الاستراتيجي |
| المحكمة الجنائية الدولية (ICC) | التحقيق في الوضع بدولة فلسطين | جنائية (مسؤولية فردية) | جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (مثل التجويع) | نزع الحصانة عن القيادة السياسية والعسكرية وتقييد حركتها الدولية. |
| محكمة العدل الدولية (ICJ) | دعوى الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا) | مدنية/دستورية (مسؤولية دولة) | انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية | إنشاء سابقة قانونية دولية وتشجيع تدخل الدول الثالثة في المساءلة. |
| محكمة العدل الدولية (ICJ) | شرعية الاحتلال الإسرائيلي (رأي استشاري) | استشاري دولي | عدم قانونية المستوطنات والاحتلال | توفير أساس قانوني لتشديد العقوبات الدولية والمقاطعة. |
المحور الثالث: التسريع نحو الوهم: الاستيطان كوقود لـ “إسرائيل الكبرى”
خرائط التوسع: كيف تُشرّع الحكومة الإسرائيلية “الضم الصامت”؟
في موازاة العزلة الدولية المتصاعدة، تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات متسارعة وواضحة لتحويل المفهوم الأيديولوجي لـ “أرض إسرائيل الكبرى” إلى واقع ملموس. يستند هذا المفهوم إلى جذور دينية وتاريخية، وتتراوح تفسيراته الجغرافية المتطرفة بين ضم فلسطين التاريخية بالكامل أو التوسع ليشمل مناطق من الأردن وسوريا ولبنان، بل وامتداداً من نهر النيل إلى نهر الفرات. وبالرغم من وجود قوى سياسية إسرائيلية علمانية ويسارية تعارض الفكرة وترى أنها تعيق السلام وتهدد الطابع الديموغرافي للدولة، إلا أن اليمين المتطرف هو المهيمن حالياً.
تشير المعطيات إلى أن عام 2024 هو عام بداية “ضم الضفة الغربية” الفعلي، حتى وإن لم يتم الإعلان عنه رسمياً. وتعمل الحكومة الإسرائيلية بصورة حثيثة لضم الضفة الغربية من خلال تشريع قوانين تُمهد لذلك، وفرض وقائع جديدة على الأرض. وتشتمل هذه السياسات على تكثيف البناء الاستيطاني وتوسيع الوجود الإسرائيلي في مناطق (ج) و(ب)، وتقليص المساحة الفلسطينية، وهدم أكثر من 1200 مبنى فلسطيني.
إن استراتيجية اليمين الإسرائيلي المتطرف تكمن في استغلال اللحظة الدولية المشحونة لفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض قبل أي تسوية محتملة، مما يضمن أن الدولة الفلسطينية الموعودة دولياً لن تكون سوى كيان مجزأ بلا أراضي متصلة. إنهم يرون أن تدهور العلاقات الدولية يزيل أي التزام أخلاقي بحل الدولتين، وبما أن العالم يوجه الانتقادات على أي حال، فإن التوسع يجب أن يستمر.
عنف المستوطنين كآلية لـ “التهجير الصامت”
يُعد عنف المستوطنين جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية الحكومية غير الرسمية للضم الصامت. فوفقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي، وصل عدد العمليات العنيفة للمستوطنين ضد الفلسطينيين إلى 618 عملية في عام 2024، مع ارتفاع كبير في عام 2025. ويُنظر إلى هذا العنف كـ “جزء من مشروع طرد الفلسطينيين من أماكن وجودهم، من خلال فرض نظام من الإرهاب عليهم دون أدنى محاسبة لهم“.
لقد أدى تفاقم ضعف السلطة الفلسطينية على الأرض، نتيجة لسياسات الضم والاستيطان، إلى تعميق هذا التناقض. ففي حين يدعو قرار الجمعية العامة إلى إقامة دولة ترتكز على “سلطة فلسطينية مُصلحة“، فإن هذا المطلب يفتقر كلياً إلى أي ارتباط بالواقع السياسي الراهن للطرفين. يسمح هذا التناقض لإسرائيل بإنكار أهمية القرار، بحجة أن “الشريك” غير موجود أو غير مؤهل، بينما يمضي مشروع “إسرائيل الكبرى” في تفتيت الأراضي وتهجير السكان.
كما أن هذا التغوّل لا يقتصر على الأراضي الفلسطينية، بل يمتد إلى المحيط الإقليمي. فقد ربط محللون بين العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في لبنان وسوريا والسعي لـ “إعادة رسم التوازن الإقليمي لصالح إسرائيل” في إطار تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى“. إن هذه الاعتداءات ليست دفاعية بحتة، بل تهدف إلى استنزاف الأطراف الإقليمية المحيطة، وهو ما يقف عقبة أمام تحقيقه الرفض العربي والدولي.
المحور الرابع: ارتداد التطبيع: تقويض اتفاقات أبراهام في عالم متعدد الأقطاب
التطبيع بعد الطوفان: مصالح الحكومات في مواجهة الارتداد الشعبي وتحدي التعددية
كانت اتفاقيات أبراهام، الموقعة في 2020، تهدف إلى تجاوز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتركيز على التعاون الاقتصادي والأمني في مواجهة إيران. لكن حرب غزة أدت إلى قلب هذا السياق تماماً. فقد وصلت عملية توسيع نطاق الاتفاقات، التي كانت إدارة بايدن تركز عليها لتشمل المملكة العربية السعودية، إلى “طريق مسدود” على خلفية الدمار الهائل والضحايا المدنيين.
لقد أظهرت الحرب أن التطبيع المجاني، الذي يُمنح دون اشتراط إنهاء الاحتلال، يضعف الموقف الفلسطيني ويشجع الاحتلال على التمادي في سياساته الاستيطانية والعدوانية.
على الرغم من التوترات، صمدت الاتفاقات الإبراهيمية على المستوى الحكومي حتى الآن، مدعومة بالمصالح الاستراتيجية والدفاعية. ومع ذلك، تم تجريد هذه العلاقات من أهدافها المعلنة للسلام، وأصبحت ترتكز بشكل شبه كلي على المصالح الأمنية والصفقات العسكرية، كما هو الحال مع المغرب والبحرين.
في المقابل، تضاءل الزخم الشعبي والاقتصادي بشكل كبير وتقوض بالكامل. وقد اضطرت الإمارات، على سبيل المثال، إلى تعليق مشاريع مهمة، مثل صفقة الاستثمار المشترك في حقل الغاز البحري مع شركتي بريتيش بتروليوم و نيوميد. كما تراجعت حركة السياحة، وهددت الإمارات بخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية رسمياً. أما البحرين، فقد غادر سفيرها تل أبيب، لكنها حافظت على أهمية العلاقة الأمنية والدفاعية.
هذا يشير إلى أن العلاقة تحولت إلى “بقاء اضطراري” وليست “سلام دائم”، وهي علاقة هشة أمام الضغوط الداخلية.
بدائل إقليمية ونهاية مبرر “المظلة الأمنية”
إن البيئة الجيوسياسية الإقليمية تتغير بسرعة، مما يهدد الأساس الاستراتيجي لاتفاقيات أبراهام. فقد ساهم تطبيع العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في تقليص الحاجة إلى “المظلة الأمنية” الإسرائيلية/الأمريكية التي كانت الدافع الرئيسي للاتفاقات.

وفي هذا السياق، برزت أطر إقليمية مضادة. فقد طرحت إيران مبادرة “مودّة” كإطار للتعاون الإسلامي يستثني إسرائيل لأسباب دينية. كما دخلت تركيا بقوة على خط المواجهة، حيث علقت أنقرة علاقاتها التجارية مع إسرائيل بسبب الحرب، وطرحت إطاراً اقتصادياً جغرافياً خاصاً بها كبديل للمشاريع الغربية في المنطقة. هذه التحركات تعزز عزلة إسرائيل الإقليمية.
علاوة على ذلك، فإن التحول العالمي نحو التعددية القطبية، وتسارع وتيرة هذا التحول بسبب التنافس الأميركي الصيني وتشكيل تكتلات مثل مجموعة “بريكس” الموسعة (التي تضم الإمارات و مصر و إيران)، يقلل من الدافع للانضمام إلى الأطر التي ترعاها الولايات المتحدة مثل الاتفاقات الإبراهيمية.
الاستنتاج هنا هو أن حرب غزة أعادت فرض مركزية القضية الفلسطينية كشرط إلزامي لأي تطبيع موسع، مما يعكس فشل استراتيجية تجاوز الصراع.
الخاتمة: دعوة للوعي الاستراتيجي وتحديات المستقبل السوري والعربي
اليقظة الاستراتيجية: استثمار عزلة إسرائيل المتنامية لمواجهة التحدي
تكشف التحليلات أن إسرائيل تقف اليوم في تناقض استراتيجي حاد: فمن جهة، هي تواجه عزلة دبلوماسية غير مسبوقة (مع فقدان الدعم السلبي الغربي) وملاحقة قانونية تاريخية (ICC و ICJ)، ومن جهة أخرى، تواصل الحكومة الإسرائيلية تغوّلها الأيديولوجي السريع نحو أسطرة “إسرائيل الكبرى” عبر ضم الضفة وتصفية ما تبقى من مساحة الدولة الفلسطينية.
- إن هذه العزلة المتنامية، خاصة مع تحول الرأي العام الغربي ونجاح حركات المقاطعة في إحداث أثر اقتصادي، تمثل فرصة استراتيجية يجب استغلالها. وتؤكد التطورات الأخيرة أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، من التعددية القطبية إلى تزايد نفوذ القوى الإقليمية مثل تركيا، تضع إسرائيل في موقف دفاعي، وتمنح الدول العربية فرصة لتغيير قواعد اللعبة الإقليمية.
- إن قيام دولة فلسطينية، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو “حق، وليس مكافأة“، وأن إنكار هذا الحق “سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان“. وقد حذر غوتيريش من أن الاستمرار في إنكار العدل لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية.
- إن التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك التداعيات المباشرة للتغول الإسرائيلي على الجبهتين السورية واللبنانية 14، تتطلب من القارئ السوري والعربي وعياً استراتيجياً عميقاً. من الضروري معرفة واستيعاب ما يجري حولهم من تداعيات دولية (دبلوماسية وقانونية واقتصادية) كي يَستفيدوا في اتخاذ مواقف تتوازي مع التحديات التي يواجهونها نتيجة تغوّل إسرائيل في المنطقة والعالم.
- إن قوة الموقف العربي في هذه المرحلة لا تكمن في الدعم العسكري بالضرورة، بل في اليقظة الاستراتيجية واستثمار العزلة القانونية والدبلوماسية لإسرائيل واستئناف مركزية القضية الفلسطينية في الخطاب الإقليمي والدولي. يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي هو تحويل “الاعتراف بحق قيام الدولة” إلى واقع عملي على الأرض، عبر التنسيق الإقليمي الفعال الذي يواجه مشروع الضم بآليات قانونية واقتصادية وسياسية متضافرة.
إن الإدراك بأن مسار العزلة الإسرائيلية هو مسار لا رجعة فيه، يمنح شعوب المنطقة الأمل في إمكانية تغيير الواقع القائم بالضغط المستمر والمتوازن.