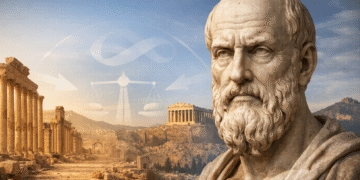فضفضة إغاثية
في حديث جمعني بأحد القامات الوطنية السورية التي كرّست سنوات من عمرها للعمل الإنساني خلال الثورة السورية، وصف لي تجربة مؤلمة بكلمات حادة:
"أُصبت بما يمكن تسميته ب"متلازمة إحباط الناشطين والمانحين". وأردف قائلاً: "هذه المتلازمة ليست حالة نفسية عابرة، بل واقع ثقيل يتسلل بصمت إلى قلوب وعقول من دخلوا ساحة الإغاثة بإيمان عميق ورسالة إنسانية. ورغم أن مشاريعهم قامت على أسس قانونية وأخلاقية ومؤسساتية رصينة، فإن الإرهاق الأخلاقي والخذلان السياسي كانا أقوى من قدرتهم على الاستمرار".
سألت محدثي: ما هي العوامل التي تصيب الحماسة التي تبدأ نشيطة ثمَّ يخور هذا الحماس ويصاب بالفتور العمل المجدي والمستمر ؟ أجابني بسردٍ واقعي عن تجاربه التي سأعرج عليها خلال هذا المقال.
من الإيمان العميق إلى الانسحاب الصامت: لماذا تخبو حماسة الناشطين؟
يبدأ كل شيء بتدفق إنساني جارف. ناشطون يتوسلون المساعدة، مانحون يتبرّعون بسخاء، ونداءات إغاثة تلامس القلوب. لكن مع تصاعد الكارثة السورية، ومع تضخم أعداد النازحين واللاجئين، بدأت وتيرة الدعم تتراجع، وتسلل الشعور بالعجز إلى النفوس.
إن الاحتكاك اليومي مع المعاناة، والمآسي المتكررة، والموت والدمار، والنهب المنظّم من قبل بعض ضعاف النفوس، كلها عوامل ولّدت “الإنهاك الأخلاقي“، حيث يشعر الناشط بأن جهوده تذهب هباءً، فيقرّر الانسحاب، رغم أنه كان مدفوعاً بغريزة البقاء.ولهذا السبب أطلق عليه محاوري مجازاً “متلازمة إحباط الناشطين والمانحين“.
وهذا الانسحاب، رغم كونه قراراً فردياً، يتحوّل إلى ظاهرة جماعية كارثية، تترك المستضعفين وحدهم في الميدان.
حين تتحوّل المساعدات إلى سلاح سياسي: إحباط المانحين الدوليين
مع انتقال زمام الأمور من الأفراد إلى المؤسسات الدولية وحكومات بعض الدول، بدأت متلازمة الإحباط تتخذ شكلاً أكثر تعقيداً. بزخارف دبلوماسية وذرائع سياسية، تم التراجع عن الدعم الإنساني، وتحوّلت الأولويات نحو تمويل صفقات النفوذ وشراء الولاءات.
“صار تمويل الإغاثة مرهوناً بمصالح جيوسياسية ضيقة؛ فصار يُضخ المال لإطالة أمد الحرب بدل تضميد جراحها.” – اقتباس مايا سمعان
التمويه السياسي للمساعدات لم يكن سوى غطاءٍ لإعادة توجيه الأموال لدعم أطراف النزاع أو تسليح القوى المتناحرة، تاركين المدنيين في مواجهة مصيرهم بلا حماية ولا طعام.
عندما تُقصى القضايا العادلة: صمت الدول وصوت الشعوب
منذ العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى، بدأت تتكشّف ازدواجية المعايير الدولية. الشعوب خرجت تحتج وتصرخ في العواصم الحرة، بينما صمتت الحكومات وسقطت أخلاقيّاً.
“في الشرق الأوسط الجديد، تحوّل القتل والتدمير إلى طقسٍ ثيوقراطي-سياسي تُقرَّب فيه الضحية إلى مذبح الهيكل المزعوم، لتُذبح العدالة فداءً للمصالح الكبرى”. – اقتباس مايا سمعان
أصبحت قضايا الشعوب العادلة -من فلسطين إلى سوريا و… و…. إلخ- في هوامش تقارير السياسات، بعد أن كانت في صلبها. وتحوّلت الجغرافيا العربية إلى مختبر لتجارب التقسيم والتطويع السياسي. وأصبح على الشعوب في المنطقة أن تقول”هللويا..هللويا يا إبراهام“
هل يمكن احتواء متلازمة الإحباط بعد الحرب؟
في لحظة ما، حين تهدأ المدافع، ويغيب دويّ الانفجارات، يفترض أن يُفتح الباب أمام البناء والإغاثة. لكن الواقع مختلف.
المراقبون السياسيون يبدون عاجزين عن تفسير المسار العالمي، إذ تضيع الحقائق وسط ضباب المصالح الدولية التي تشابه لعبة الخفة “الكشتبان والأكواب الثلاث“.
أسباب استمرار المتلازمة بعد الحرب:
- تسييس العمل الإنساني: حيث يُربط الدعم الإغاثي بالتوجهات السياسية للدولة أو المؤسسة.
- الإرهاق العاطفي والتطبيعي مع المأساة: مع تكرار الكارثة، تفقد المأساة قدرتها على التأثير.
- الفساد في سلاسل المساعدات: منظمات وهمية، وسرقة التبرعات، وغياب الشفافية.
- تبدل أولويات المانحين: نحو قضايا أكثر “استثماراً” أو مناطق نفوذ جديدة.
- غياب رواية إعلامية أخلاقية تُعيد تسليط الضوء على المعاناة.
في الختام: ربح الرهان يبدأ من الصمود الأخلاقي
رغم الصورة القاتمة، ثمة بارقة أمل. بعض الأفراد، وعدد من المؤسسات النزيهة، وحتى دول هامشية شريفة، بدأت ترفض الرضوخ لمتلازمة الإحباط.
هؤلاء رفعوا شعارات حيّة:
"المقاطعة، التطوّع، التبرّع، الاحتجاج، الإعلام الحر، والعمل من أجل إنقاذ الإنسان."
لا شيء أقوى من صوت الضمير الإنساني حين يتجاوز حاجز الصمت. والأمل الحقيقي يكمن في استمرار المقاومة الأخلاقية لهذه المتلازمة، لإعادة الإيمان بأننا قادرون، ولو وحدنا، على تغيير العالم.