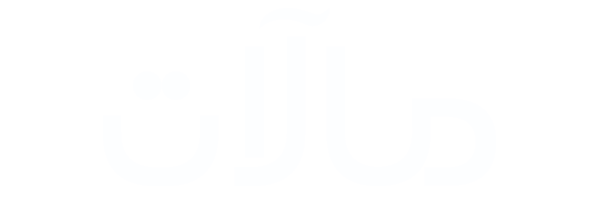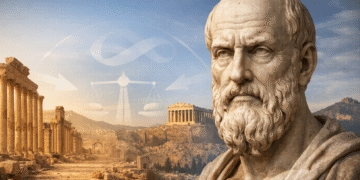استهلال:
جذور فوبيا الإسلام وصعودها في الغرب
برزت ظاهرة فوبيا الإسلام (الإسلاموفوبيا) في الخطاب الغربي الحديث بشكل متزايد خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مدفوعة بحملة منظمة هدفت إلى شيطنة المسلمين وتقديم الإسلام كـ“عدو جديد” للغرب بعد انتهاء الحرب الباردة. تقف وراء هذه الحملة أوساط فكرية وسياسية يمينية متحالفة مع اللوبي الصهيوني؛ إذ أدركت إسرائيل وحلفاؤها في الغرب منذ السبعينيات أن أفضل وسيلة لتبرير قمع الفلسطينيين تحت الاحتلال هي تصوير ذلك كجزء من معركة حضارية أوسع ضد “الخطر الإسلامي”. وبحلول أواخر الثمانينيات، بدا كما لو أن إسرائيل منخرطة في مواجهة شاملة مع العالم الإسلامي، واستخدمت سلاح تشويه صورة الإسلام والمسلمين – وقود الإسلاموفوبيا – بهدف إبقاء رياح الرأي العام الغربي تهبّ في صالحها.
في تلك الفترة، رُسمت صورة نمطية للمسلم في الإعلام الغربي كمتطرف وإرهابي محتمل، وساهم كتّاب مثل المستشرق برنارد لويس والمنظّر صامويل هنتنغتون (صاحب نظرية “صدام الحضارات”) في إضفاء بعد فكري على هذا التخويف الممنهج. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتزامن صعود الإسلاموفوبيا مع دعم سياسي وإعلامي غير محدود لإسرائيل؛ فقد حرص اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وأوروبا على ربط صورة العربي والمسلم بالإرهاب ومعاداة قيم “العالم الحر”. وكانت النتيجة السيطرة إلى حد بعيد على عقول شريحة واسعة من الشعوب الأمريكية والأوروبية، بحيث تقبّلت بسهولة سياسات “الحرب على الإرهاب” بعد 2001 ودعمت دون اعتراض يُذكر الحروب في البلدان الإسلامية من أفغانستان إلى العراق، وكذلك استمرار الانحياز لإسرائيل في قمعها للفلسطينيين.
تشير أبحاث حديثة إلى ترابط وثيق بين صناعة الإسلاموفوبيا واللوبيات المساندة لإسرائيل. على سبيل المثال، كشف تحقيق استقصائي أن نحو 80% من الجهات الممولة لشبكات الإسلاموفوبيا في الغرب كانت قد دعمت مالياً أو علنياً قضايا تروج لـ”دولة إسرائيل”. وبالمثل، وجدت دراسة أكاديمية أن 45 من أصل 60 مؤسسة خيرية كبرى تموّل الإسلاموفوبيا في أمريكا لها ارتباط مباشر بتمويل الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة. هذه المعطيات تؤكد أن الصهيونية العالمية لعبت دوراً محورياً في تأجيج الكراهية ضد المسلمين، مستخدمة ذلك كستار دخاني لتبرير جرائمها وتوسيع نفوذها. وكما يقول محللون:
كان الهدف الأساس هو إبقاء الرأي العام الغربي تحت تأثير الخوف من الإسلام لتسهيل تمرير أجندات سياسية؛ سواء غزو بلدان إسلامية أو دعم غير مشروط لإسرائيل.
لكن اليوم، بعد عقود من هذه الهيمنة الخطابية، يبدو أننا أمام نقطة تحول تاريخية قد يُطلق عليها مرحلة “The Game is Over” (انتهت اللعبة). فقد بدأت الرواية المهيمنة التي تربط الإسلام بالعنف وتصور المسلمين كتهديد وجودي بالتصدع من الداخل في الغرب نفسه. تجلّت هذه التحولات مؤخراً في نتائج الانتخابات المحلية بعدة ولايات أمريكية – وعلى رأسها حدث مدوّي في نيويورك – تزامنت معها تغيرات ملحوظة في نبرة الخطاب لدى بعض قادة أوروبا تحت ضغط الشارع. فهل يمكن القول إنّ فوبيا الإسلام التي زرعتها الصهيونية في العقل الغربي بدأت تنهار في عقر دارها؟ وما دلالات ذلك لنا في العالم العربي والإسلامي؟
الحدث المفاجئ في نيويورك يهز أركان اللوبي الصهيوني
في مدينة نيويورك – التي تعد العاصمة السياسية والإعلامية للعالم – وقع ما اعتبره كثيرون خارج الحسابات تماماً: فوز سياسي شاب مسلم من أصول مهاجرة بمنصب عمدة المدينة الأكبر في الولايات المتحدة. هذا الشاب الثلاثيني، واسمه زهران ممداني، خاض السباق الانتخابي رافعاً شعار “العدالة لا تتجزأ” ومتحدّياً أعراف المؤسسة السياسية التقليدية في أمريكا. لم يتردد ممداني خلال حملته في كسر كل المحرمات السياسية: انتقد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل جهاراً، ووصف ما ترتكبه في غزة بأنه إبادة جماعية، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية قائلاً:
“أعترف بإسرائيل، لكنني لن أعترف بحق أي دولة في أن تكون قائمة على أساس عنصري ديني”.
مثل هذا الخطاب كان يُعد انتحاراً سياسياً في الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة، فما بالك لشاب مسلم يسعى لحكم مدينة تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم.
جاءت النتيجة مدوّية: فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك 2025 بفارق مريح على منافسيه، في انتخابات شهدت إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق. فقد ارتفعت نسبة المشاركة بشكل هائل لتبلغ حوالي 42% من الناخبين المسجلين مقابل 23% فقط في الانتخابات الماضية عام 2021. وصوّت ما يزيد على مليوني ناخب في الاقتراع العام – وهو أعلى رقم تصويت تشهده نيويورك منذ عام 1969. بل إن ممداني حصد وحده نحو مليون صوت، أي ما يعادل تقريباً إجمالي الأصوات التي شاركت في انتخابات 2021 كلها! هذه الأرقام الصادمة أشارت إلى مدى الحماس الذي أثاره ترشح شخصية بمواصفات ممداني: فهو مسلم الديانة، اشتراكي التوجّه، مهاجر الأصول، ومنفتح تماماً في طرح أفكاره التقدمية. لقد نجح في بناء تحالف قاعدي عابر للهويات جمع بين الليبراليين البيض في بروكلين الراقية، والجاليات المهاجرة الكادحة في أحياء كوينز وبرونكس، وقطاع واسع من الناخبين السود في المدينة.
اعتمد ممداني على حملة غير تقليدية قامت على تعبئة شعبية كثيفة، مستفيداً من خبرته السابقة كمنظم مجتمعي ودعم منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين (DSA). جذب إلى صفوف متطوعيه جيشاً من الشباب المتحمس بلغ عدده 50 ألف متطوع مسجّل، نصفهم تقريباً نزلوا فعلياً إلى الميدان يطرقون الأبواب ويكلمون الناس. وبلغ مجموع عمليات طرق الأبواب التي نفذوها 1.6 مليون مرة خلال الحملة ما أثمر عن مئات آلاف المحادثات المباشرة مع الناخبين كانت حاسمة لقلب المزاج العام. هذا الجهد التنظيمي القاعدي غير المسبوق – والذي وصفته الصحافة المحلية بأنه “عملية طرق أبواب غير معهودة في تاريخ نيويورك” – ترافق مع استخدام ذكي لمنصات التواصل الاجتماعي لجذب الأجيال الشابة (خاصة TikTok وإنستغرام). وهكذا تمكن ممداني من تحويل طاقة الغضب والإحباط لدى الشباب حيال الأوضاع القائمة إلى أصوات في صناديق الاقتراع؛ إذ تشير التحليلات إلى أن 78% من الناخبين الشباب (تحت 30 عاماً) صوّتوا له، وسُجّل ارتفاع كبير في عدد المقترعين لأول مرة بفضل جهود حملته.
لقد حطّم ممداني بتجربته هذه كثيراً من الصور النمطية والمحظورات. فمن كان يتخيّل قبل أعوام قليلة أن يرى مسلمٌ ملتحٍ يحمل اسماً عربياً (زهران) يتبوأ رئاسة مدينة نيويورك ويؤدي اليمين الدستورية على القرآن الكريم؟ بل والأكثر إثارة أنه فعل ذلك دون أن يقدم أي تنازل في هويته أو مبادئه؛ فقد خاطب أنصاره ليلة الفوز قائلاً بالعربية: “أنا منكم ولكم”، مؤكداً اعتزازه بجذوره الإسلامية وخلفيته المهاجرة وفي خطاب النصر، شكر ممداني شرائح متنوعة ساهمت في نجاحه – من أصحاب البقالات اليمنيين إلى سائقي التاكسي السنغاليين والممرضات الأوزبكيات – في احتفاء بتنوع نيويورك الثقافي لقد بدا وكأن “الحلم الأمريكي” يرتدي حلّة جديدة متعددة الأعراق والأديان، وهذا بحد ذاته صفعة لخطاب الكراهية الذي شيطن المسلمين لعقود.
ولم يتأخر الزلزال السياسي في نيويورك عن إحداث هزات ارتدادية من واشنطن إلى تل أبيب. فخصوم ممداني في الداخل – من قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي التقليديين – أصابهم الذهول، وراح بعضهم يحذر من “تجربة اشتراكية خطرة” في أكبر مدينة أمريكية. أما اللوبيات الصهيونية الأمريكية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك AIPAC)، فقد تلقت أكبر صفعة انتخابية في تاريخها الحديث داخل الولايات المتحدة. إذ كانت قد أنفقت هي وحلفاؤها الملايين لإسقاط ممداني، وحرّضت الإعلام ضده بوصفه “متطرف معادٍ لإسرائيل” وحتى أطلقت شائعات سخيفة بأنه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في نيويورك. ورغم ذلك، فشلوا فشلاً ذريعاً أمام مد شعبي غاضب تغذّى من مشاهد المجازر الإسرائيلية في غزة خلال العامين الماضيين. حتى إنّ شريحة من اليهود الأمريكيين أنفسهم تحدّت إملاءات اللوبي الصهيوني؛ فشكّل مئات النشطاء اليهود مجموعة “يهود من أجل زهران” وشاركوا في حملته دعماً له، رافعين شعار “ليس باسمي” اعتراضاً على جرائم إسرائيل.
تشير التقديرات إلى أن قرابة ثلث الناخبين اليهود بنيويورك أعطوا أصواتهم لممداني رغم حملة التخويف ضده – في ظاهرة غير مسبوقة تكشف انقساماً عميقاً داخل الصف اليهودي الأمريكي حول إسرائيل.
أما في إسرائيل، فكان وقع الحدث أشبه بالكابوس. سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون صرّح علناً أنه “قلق للغاية” من فوز ممداني، واصفاً إياه بأنه تطور خطير. وذهب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف، إلى أبعد من ذلك بالقول إن انتخاب ممداني “وصمة عار ستظل تذكر إلى الأبد كنقطة انتصر فيها اللاسامية على المنطق”. بل إن وزيراً آخر (شاحاك) دعا يهود نيويورك إلى “الهجرة لإسرائيل قبل فوات الأوان” زاعماً أن المدينة “سلّمت مفاتيحها لمناصر حماس”. الصحف العبرية خرجت بعناوين تنذر بالخطر؛ فوصفت يديعوت أحرونوت الحدث بأنه “عاصفة سياسية في نيويورك” وأن فوز ممداني “جزء من توجه أوسع يسعى لتحدي حق الدولة اليهودية الوحيدة في العالم بالوجود”. وأكدت (في نبرة يائسة) أنه ليس مصادفة حدوث ذلك في مدينة تضم واحدة من أكبر التجمعات اليهودية عالمياً. هكذا، بدا المشهد وكأن عرش البيت الأبيض نفسه اهتزّ – على حد تعبير بعض المعلقين – من ارتدادات الزلزال النيويوركي، وسط تساؤلات حول ما إذا كنا نشهد بداية أفول نفوذ “تابوه” التخويف من الإسلام الذي طالما استخدم لإحكام القبضة الصهيونية على السياسة الأمريكية.
من هو زهران ممداني؟ سيرة وتحوّل غير اعتيادي
قد يتساءل كثيرون: من هذا الشاب الذي قلب معادلات نيويورك السياسية؟ زهران كوامي ممداني يبلغ من العمر 34 عاماً (من مواليد 1991)، قصته الشخصية مزيج فريد يعكس العولمة الثقافية والالتقاء الحضاري. هو ابن لعائلة أكاديمية مرموقة؛ فوالده محمود ممداني أكاديمي شهير من أصل أوغندي-هندي مختص بعلم الأنثروبولوجيا ودراسات أفريقيا، وقد درّس في أعرق جامعات أمريكا (كولومبيا وغيرها). اشتهر الأب بكتابه “المسلم الجيد والمسلم السيء” (Good Muslim, Bad Muslim) الذي صدر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وفيه انتقد بشدة النزعة الأمريكية لتصنيف المسلمين وتصوير بعضهم كـ“جيدين” موالين للغرب وآخرين كـ“سيئين”. هذا الفكر النقدي زرع في ذهن زهران منذ صغره ووعّاه بمخاطر شيطنة جماعة دينية كاملة لأهداف سياسية. أما والدة زهران، فهي المخرجة الهندية المعروفة ميرا ناير (هندوسية الديانة)، صاحبة أفلام عالمية حازت جوائز وركزت في مضامينها على قضايا الهوية وما بعد الاستعمار. نشأ زهران الوحيد لأبويه إذن في بيئة ثقافية ثرية متعددة الأديان والأعراق: أب مسلم (شيعي المذهب) وأم هندوسية، وجدّة (أم والدته) يهودية كانت متزوجة سابقاً من يهودي غير صهيوني حسب ما يُروى. هذا المزيج جعل قضية مناهضة العنصرية ومحاربة الاستعمار حاضرة في نقاشات المنزل، كما انغمس منذ مراهقته في نشاط والدته الفني ذو الرسالة الاجتماعية وأعمال والده الفكرية حول التحرر من الاستعمار.
وُلد زهران عام 1991 في العاصمة الأوغندية كمبالا – حيث كان والده يعمل هناك في ذلك الوقت – وقضى بضع سنوات من طفولته في جنوب أفريقيا خلال حقبة ما بعد الفصل العنصري. وفي سن السابعة انتقل مع أسرته إلى نيويورك، حيث استقروا في حي مانهاتن. اندمج الصبي سريعاً في الحياة الأمريكية دون أن يفقد ارتباطه بهويته الأصلية؛ فالمنزل يتحدث بأربع لغات واللهجات (الإنجليزية والأوردية والعربية والهندية)، وجيرانه من شتى الجنسيات في مدينة تعد بحق بوتقة انصهار عالمية. أظهر زهران منذ مراهقته ميولاً قيادية وذكاءً اجتماعياً لافتاً، وكان نشطاً في اتحاد الطلبة بمدرسته الثانوية. ثم التحق بجامعة بودوين المرموقة في ولاية ماين، وفيها أسس فرعاً لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) تضامناً مع القضية الفلسطينية. لم يكن النشاط السياسي جديداً عليه.
لقد تربى على التعاطف مع المظلومين أياً كانت هويتهم. يُروى أنه شارك في مظاهرات احتجاجية منذ سن 17 عاماً، وكان صوته جهورياً في رفض حرب العراق وفي انتقاد سياسات إدارة بوش الإبن آنذاك.
بعد تخرّجه، انخرط ممداني في العمل العام عبر بوابة الحملات الانتخابية. عمل مديراً لحملة أحد المرشحين التقدميين لمجلس المدينة وهو لما يزل في الثانية والعشرين، فاكتسب خبرة عملية مبكرة في دهاليز السياسة المحلية. ومع صعود الموجة اليسارية داخل الحزب الديمقراطي خلال العقد الماضي – ممثلةً بشخصيات مثل بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز – وجد ممداني بيئة مواتية لتحقيق طموحاته. في 2020، نجح لأول مرة بانتخابه عضواً في مجلس ولاية نيويورك (ممثلاً عن منطقة أستوريا في كوينز)، ليصبح واحداً من أول النواب الاشتراكيين الديمقراطيين في الولاية. هناك بدأ يثير الانتباه بمواقفه الجريئة تحت قبة المجلس: ندّد علناً بعنف الشرطة ضد الأقليات وطالب بتخفيض ميزانية شرطة نيويورك لصالح تمويل التعليم والإسكان، كما قدم مشروع قانون لحظر تمويل أنشطة المستوطنات الإسرائيلية انطلاقاً من نيويورك. ولم يتردد في تنظيم وقفات احتجاجية نصرةً لفلسطين حتى خلال حملته الانتخابية التمهيدية لرئاسة البلدية. كل ذلك صنع له اسماً مميزاً كسياسي صاعد “خارج عن المألوف” لا يخشى ضرب الخطوط الحمراء.
شخصية ممداني الكاريزمية لعبت دوراً كبيراً في التفاف الأنصار حوله. فهو متحدث مفوّه سريع البديهة، قادر على صياغة رسائل شعبية بسيطة تصل إلى قلب المواطن العادي. وقد استثمر مهاراته الفنية أيضاً لكسب التعاطف؛ فله تجربة سابقة في “غناء الـرّاب” استمرت لعامين، حيث أنتج أغانٍ تمزج بين هموم المهاجرين وإيقاعات الهيب هوب، مما قرّبه من الشباب. كما أنه يعرف سبع لغات بدرجات متفاوتة – بينها العربية والإسبانية والبنغالية – مما ساعده على التواصل المباشر مع عمال البوديغا اليمنيين وسائقي الأجرة البنجاليين وغيرهم في نيويورك بلغاتهم الأم خلال الحملة. صورة ممداني كسليل مهاجرين فقير نسبياً ويتنقل بالدراجة الهوائية في شوارع بروكلين، سهلت عليه تقديم نفسه كنقيض لخصومه المدعومين من أصحاب المليارات.
لعل من المفارقات أن منافسه الرئيسي كان الحاكم السابق أندرو كومو – أحد أعمدة المؤسسة التقليدية – الذي حاول العودة للمشهد بعد فضائح أجبرته على الاستقالة، فتحوّل السباق بينهما إلى صراع بين “الحرس القديم” و“جيل جديد” يجسد روح التغيير.
زوجة ممدان من سوريا
في حياته الشخصية، تزوج زهران حديثاً من شابة مسلمة سورية المولد، تُدعى رَما دويجي وتبلغ 28 عاماً. رما نفسها فنانة عصامية متميزة في مجال النحت والرسم، درست الفنون الجميلة وشاركت في معارض كبرى داخل الولايات المتحدة وخارجها. تتناول أعمالها الفنية موضوعات اجتماعية وسياسية تقدمية، منها معاناة الشعب الفلسطيني وثورات الشعوب ضد الظلم، ما يعكس تقاطعاً وجدانياً عميقاً مع قيم زوجها. شكّل ظهور رما إلى جانبه خلال الحملة الانتخابية إضافة رمزية مهمة؛ فهي مسلمة محجبة جزئياً ذات شخصية مستقلة تعمل في مجالها، وقد حرص ممداني على الإشادة بدعمها ونجاحاتها المهنية بمعزل عنه. هذه الصورة لثنائي مسلم شاب منخرط في الشأن العام بفكر منفتح.
ساهمت “رَما دويجي“في تفكيك الكثير من الصور النمطية لدى الرأي العام الأمريكي حول دور المرأة المسلمة أو طبيعة الأسر المسلمة. حتى أن بعض وسائل الإعلام امتدحت رما بوصفها “السيدة الأولى الأصغر سناً والأكثر تحرراً في تاريخ نيويورك”، معتبرةً أنها ستكسر بدورها حاجزاً آخر بمجرد دخولها الساحة إلى جانب زوجها.
جدير بالذكر أن ممداني يعرّف نفسه سياسياً بأنه “اشتراكي ديمقراطي مسلم”. والجمع بين هذه الأبعاد لم يكن سهلاً في سياق سياسي أمريكي مألوف على ثنائية الديمقراطي/الجمهوري فقط. فكلمة “اشتراكي” بالذات كانت إلى عهد قريب سُبّة انتخابية تُنهي مستقبل أي مرشح يجرؤ على تبنيها. لكن تغيرات المشهد – خصوصاً بعد حملة بيرني ساندرز الناجحة في تعبئة الشباب 2016 و 2020 – جعلت المصطلح أقل إثارة للرعب مما كان عليه. ومع ذلك، يُحسب لممداني شجاعته في تبني لقب “اشتراكي” صراحةً؛ إذ قال في إحدى المناظرات:
“أنا مسلم واشتراكي، وهذا جزء من إيماني بالعدالة الاجتماعية”.
ولعل التوقيت كان إلى جانبه؛ فبعد سنوات ترامب العاصفة، بات قطاع واسع من الشباب يتوق لتحولات جذرية، ولم تعد الشعارات الوسطية التقليدية تجتذبهم. ممداني فهم هذه اللحظة جيداً وربط بين طروحه المحلي حول خفض تكاليف المعيشة وبين مواقفه الأخلاقية الخارجية، ليقدم خطاباً متكاملاً يعطي الأولوية للإنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه – سواء كان ذلك طفلاً فقيراً في برونكس أو طفلاً تحت القصف في غزة.
كرة الثلج بدأت في التدحرج: ما بعد فوز ممداني
إن فوز زهران ممداني لم يكن سوى أول كرة ثلج اندفعت من قمة جبل، لتتدحرج حاملةً معها تغيرات تتجاوز حدود نيويورك. محلياً داخل الولايات المتحدة، حفّز هذا الانتصار التاريخي موجة ثقة بين الأوساط التقدمية والأقليات المسلمة. فجأةً، لم يعد مستبعداً أن نرى المزيد من “ممدانيين” آخرين على الساحة الوطنية. وبالفعل، أعلن مرشحون مسلمون أو يساريون شباب في مدن وولايات أخرى الترشح لمناصب مهمة مستلهمين تجربة نيويورك. وشهدت انتخابات محلية متزامنة نجاحات بارزة لمسلمين: غزالة هاشمي أصبحت أول مسلمة تشغل منصب نائب حاكم ولاية (في فرجينيا)، وفاز ثلاثة مرشحين مسلمين برئاسة بلديات بلدات في ميشيغان (رغم أن تلك المدن ذات غالبية عربية ومسلمة منذ سنوات). لكن الفارق هذه المرة أن الحدث لم يعد محلياً؛ انكسار الحاجز النفسي حدث في نيويورك تحديداً – القلب النابض للمال والإعلام الأمريكي – لذا فإن رمزيته وتداعياته وطنية بامتياز.
لقد رأى السياسيون التقليديون من كلا الحزبين كيف يمكن لمرشح صريح في مناهضة الصهيونية أن ينتصر رغم كل الجهود المضادة، ما بعث رسالة مفادها: الاصطفاف التام مع إسرائيل لم يعد “قدراً” سياسياً لابد منه للفوز بالأصوات.
ظهرت بالفعل بوادر هذا التحول داخل الحزب الديمقراطي. فأحد المرشحين لمجلس الشيوخ المقبل (عن ولاية رئيسية) جاهر منذ الآن برفضه تلقي أي أموال من إيباك – سابقة لم يكن يتصورها أحد من قبل. كما أن عدداً من النواب التقدميين في الكونغرس الذين أسقطهم مال اللوبي الإسرائيلي في انتخابات سابقة، عادوا يجهزون أنفسهم لخوض المعركة مجدداً بدعم شعبي هذه المرة لا يعتمد على جيوب المتبرعين الكبار. ومن المرجح أن انتخابات 2026 التشريعية ستشهد اختبارات كبرى لميزان القوى الجديد هذا؛ فإذا تمكن معسكر العدالة الاجتماعية المناصر لحقوق الفلسطينيين من انتزاع مقاعد من مرشحين مدعومين صهيونياً، فسيكون ذلك إيذاناً بانكسار هيبة اللوبي فعلياً. لقد قال أحد المحللين الإسرائيليين محذراً:
“لم يعد دعم إسرائيل مسألة مفروغاً منها؛ اليوم غدا موقفاً يثير نقاشاً عاماً حقيقياً”.
وهذا التصدع في الإجماع التقليدي حول إسرائيل هو تحديداً ما يخشاه القادة الصهاينة، لأنه يقلّم أظافر أهم أسلحتهم في أمريكا: نفوذ المال وجماعات الضغط في كواليس الحزبين.
وإلى جانب العامل الانتخابي، هناك تحوّل عميق في الرأي العام لا يمكن إغفاله. فاستطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة تُظهر تغيّراً غير مسبوق في تعاطف الأجيال الشابة مع القضية الفلسطينية. إذ أفاد استطلاع حديث بأن قرابة 70% من الأمريكيين تحت سن 35 يؤيدون وقف الدعم لإسرائيل ويعتبرون ما تقوم به في غزة عملاً إجرامياً. هذه النسبة العالية صدمت المراقبين، لأن المشهد كان معكوساً تماماً قبل عقدين فقط. وحتى في أوساط اليمين الشعبوي المحافظ – المعروفة تقليدياً بدعمها المطلق لإسرائيل – برزت تيارات وقادة بدأوا بطرح تساؤلات وانتقادات علنية لتل أبيب. فعلى سبيل المثال، وجّه الإعلامي اليميني الشهير تاكر كارلسون انتقادات لاذعة لنتنياهو وحكومته عقب حرب غزة الأخيرة، واتهمها بتوريط أمريكا أخلاقياً. كما هاجمت الناشطة المحافظة كانديس أونز الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وتحدثت عن ضرورة أن “تضع أمريكا مصالحها أولاً لا مصالح إسرائيل”.
هذه الأصوات من اليمين إلى جانب أصوات اليسار التقدمي خلقت تقاطعاً نادراً يلتقي عند إدانة التطرف الصهيوني. ولعل ذلك ما دفع نتنياهو نفسه للإقرار قبل فترة بوجود “مشكلة لدينا اسمها تيك توك” في إشارة لتأثير المنصات الجديدة على عقول الشباب في أمريكا ضد الرواية الصهيونية.
الهسبرة الصهيونية
لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي وظهور الإعلام البديل دوراً حاسماً في هذه التحولات. وفشلت منظمة الهاسبارا الصهيونية في تبرير المجازر المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة طوال عامي 2024 و 2025 نُقلت لحظة بلحظة عبر شاشات الهواتف إلى ملايين الشباب في الغرب. وشاهد الناس بأعينهم – دون رتوش إعلامية – صور الأطفال تحت الأنقاض والمستشفيات المقصوفة. هذا التدفق المستمر للمعلومات كسر احتكار الرواية الذي مارسته وسائل الإعلام التقليدية لعقود. ففي الماضي – كما يروي د. سامي (ضيف بودكاست عربي بوست) – كانت أحداث مثل اجتياح لبنان 1982 تصل الأمريكي العادي كخبر مسائي عابر يُبث لبضع دقائق ثم يُطوى. أما في حرب غزة الأخيرة، فالمشاهد الحيّة للمجازر كانت تلاحق المستخدم على مدار الساعة عبر تويتر وتيك توك وإنستغرام. وهكذا ترسّخت قناعة أخلاقية لدى قطاعات واسعة، خاصة من الشباب، بأن “ما يجري في فلسطين هو ظلم فادح يجب عدم السكوت عنه”. ولم يعد من السهل تخويف هؤلاء بشعارات “معاداة السامية” الجاهزة؛ إذ يرون بأم العين من هو المعتدي ومن هو الضحية. حتى بعض المحرّمات التاريخية بدأت تتصدع: بات نقاش دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية يدور علناً، وتجددت المطالب بتسجيل إيباك كعميل أجنبي يخضع للمحاسبة، واستُحضرت فضائح قديمة مثل حادثة هجوم إسرائيل على السفينة الأمريكية ليبرتي عام 1967 باعتبارها مثالاً على غدر حليف مزعوم – وهي قضية كادت أن تُنسى وعادت الآن لواجهة السجال.
كل هذا شكل مناخاً غير مسبوق شعرت معه المنظومة الصهيونية أن سطوتها الإعلامية والسياسية لم تعد مضمونة كما قبل.
بالطبع، لم ولن يستسلم اللوبي الصهيوني لهذه المتغيرات بسهولة. فمباشرةً بعد بروز تأثير منصات التواصل (خاصة تيك توك) في نقل حقيقة جرائم إسرائيل، تحركت قوى نافذة للحد من ذلك. وقد تكشّف مؤخراً أن شركة تيك توك تعرضت لضغوط هائلة من الكونغرس وإدارة ترامب ثم بايدن، أفضت إلى بيع حصة كبيرة منها لمستثمرين مقربين من إسرائيل، بهدف السيطرة على المحتوى المتداول بشأن فلسطين. أضف إلى ذلك حملة التشريعات المتطرفة في بعض الولايات الأمريكية التي تجرّم حركة المقاطعة (BDS) وتمنع حتى الموظفين من انتقاد إسرائيل، في تعدٍّ صريح على حرية التعبير. هذه أمثلة على محاولات اللوبي اليائسة لإيقاف عجلة التغيير، عبر تقييد منصات النشر الحر وتخويف الأصوات المناصرة للفلسطينيين بتهمة “اللاسامية”. لكن من الواضح أن السحر انقلب على الساحر؛ فالإصرار على كمّ الأفواه وشيطنة كل نقد لإسرائيل بات يُنظر إليه بامتعاض ضمن قطاعات شعبية متزايدة. وحتى بعض القادة الأوروبيين – الذين طالما تماهوا مع السياسة الصهيونية – اضطروا مؤخراً تحت ضغط شعوبهم لاتخاذ مواقف حذرة أو ناقدة. شهدنا مثلاً إسبانيا وإيرلندا تقودان حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلهجة غير معهودة محذراً إسرائيل من “عواقب إنسانية لا تُحتمل” إذا استمرت حربها وحصارها في غزة حتى ألمانيا ذاتها – تقليعة الدعم المطلق لإسرائيل – سمعت مواطنيها يهتفون بالملايين نصرةً لغزة، ولم يملك مسؤولوها إلا انتقاد عنف إسرائيل علانية وإن بشكل متأخر.
إنها أجواء دولية جديدة يمكن وصفها حقاً بأنها بداية سقوط حصن الإسلاموفوبيا الذي شُيّد لسبعين عاماً بتحالف صهيو-غربي. فحين يصبح عمدة نيويورك مسلماً مناصراً لفلسطين، وحين يهتف الآلاف في شوارع لندن وباريس نصرةً لغزة، ندرك أن سردية “الخوف من الإسلام” التي زرعتها الصهيونية بدأت تتهاوى في أهم معاقلها.
خلاصة: رسالة إلى القادة العرب – اغتنموا رياح التغيير
مشهد اليوم يبعث على التفاؤل الحذر: لقد انكشفت زيف معادلة “الإسلام عدو والحليف الوحيد هو إسرائيل” أمام شعوب الغرب، وبدأت معركة الوعي العالمية تميل في صالح الحق رغم كل أدوات التضليل الماضية. هذه التحولات تحمل في طياتها فرصة استراتيجية نادرة للعالم العربي والإسلامي ينبغي عدم التفريط بها. ومن هذا المنطلق، نخاطب قادة الدول العربية ونخبها وصنّاع الرأي فيها بجملة من النقاط والمحاور للعمل:
- التحرر من عقدة الخوف والارتهان للضغوط الخارجية: لعل من أهم دروس تجربة ممداني أن اللوبي الصهيوني ليس قدراً لا يُقهر. فإذا كان شاب أعزل من دعم “المؤسسة” قد هزم مرشحهم في نيويورك، وإذا كانت قطاعات معتبرة في أمريكا نفسها ثارت ضد نفوذهم، فإن الخوف المبالغ فيه من سطوة الصهاينة يجب أن يزول من حساباتنا الدبلوماسية والإعلامية. آن الأوان لإسماع صوتنا بقوة في المحافل الدولية دفاعاً عن قضايانا العادلة، دون خشية من ابتزاز بلغة “معاداة السامية” التي يُشهِرها البعض لإسكات أي نقد لإسرائيل. لقد بات كثير من الغربيين يدركون الآن الفرق بين انتقاد إسرائيل ككيان سياسي عنصري ومعاداة اليهود كأصحاب ديانة. وبالتالي يمكن للعرب استثمار هذا الفهم لتوسيع حملات مناصرة فلسطين وحقوق المسلمين عموماً في الغرب دون الوقوع في فخاخ التشويه القديمة.
- دعم أصدقاء العدالة في كل مكان (بغض النظر عن دينهم): المتغير المهم في السنوات الأخيرة هو ظهور شركاء وحلفاء لنا من قلب المجتمعات الغربية؛ أصوات يهودية ومسيحية وهندوسية وغيرها ترفع لواء الحق الفلسطيني وتعترض على شيطنة الإسلام. هؤلاء حلفاء طبيعيون ينبغي الاحتفاء بهم وتعزيزهم. فلم يعد مقبولاً أن نقع نحن أسرى للتصنيفات الضيقة – كأن نشكك في شخص فقط لأنه من طائفة معينة أو خلفية مختلفة – بينما قضيتنا عادلة وتتسع للجميع. على سبيل المثال، رأينا كيف تضامن عشرات الآلاف من اليهود التقدميين في أمريكا وأوروبا مع غزة ورفضوا ربطهم بجرائم إسرائيل. الواجب يقتضي مدّ الجسور مع هذه القوى وتعزيز التعاون المدني والإعلامي معها لنشكل معاً جبهة عالمية مناهضة للعنصرية والهيمنة الصهيونية. وفي المقابل، يجب نبذ أي خطاب كراهية قد يصدر من طرفنا تجاه عموم الغربيين أو أتباع الديانات الأخرى، والتركيز على أننا ضد الصهيونية كحركة استعمارية عنصرية ولسنا ضد اليهود كأصحاب ديانة.
- إعادة تقييم سياسات التطبيع والتحالفات الإقليمية: لقد انقلبت الحسابات؛ فإسرائيل التي روّج البعض أنها بوابتهم لقلوب واشنطن، أصبحت اليوم مصدر حرج لمن يرتبط بها في نظر شعوبهم وشعوب العالم. فما معنى أن يهرول بعض العرب للتطبيع والتحالف مع حكومة إسرائيلية متطرفة، فيما العالم بأسره يشاهد مجازرها وينتفض ضده؟ حان الوقت لإعادة النظر جديّاً في “اتفاقات إبراهام” وأشباهها، والتي لم تحقق للمنطقة سلاماً ولا ازدهاراً بل شجعت المحتل على مزيد من التنكيل. إن التحولات الشعبية في أمريكا وأوروبا تصب في مصلحة الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها، فلماذا نمد لها طوق نجاة بتطبيع مجاني؟ على القادة العرب أن يصغوا لنبض الشارع العربي الذي كان سبّاقاً في دعم فلسطين ورفض العدوان على غزة عبر مظاهرات مليونية. وينبغي تحويل هذا الزخم الشعبي إلى مواقف رسمية أقوى: مثل اشتراط إحياء عملية سلمية ذات مغزى، أو على الأقل وقف أي خطوات تطبيعية جديدة حتى يرضخ الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية. كذلك يمكن للدول العربية والإسلامية التنسيق لقيادة حراك دبلوماسي في الأمم المتحدة لاستصدار قرارات لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب، مستفيدين من تغير مواقف بعض الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر تفهماً الآن.
- الاستثمار في القوة الناعمة وحرب الرواية: علينا أن نعترف أن معركة الرواية كانت دائماً مكمن الضعف في أدائنا. وقد حان الوقت لتغيير ذلك عبر تبني استراتيجية إعلامية وثقافية عالمية تشرح قضايانا بلغات العالم وبمنطق يفهمه الشعوب الغربية. تجربة ممداني وغيره أثبتت أن هناك جمهوراً جاهزاً لسماع الحقيقة لكنه بحاجة لمخاطبته بلغة القيم الإنسانية المشتركة. يجب إنشاء منصات إعلامية موجهة للشعوب (وليس فقط للحكومات) تبيّن حقيقة الإسلام ديناً وحضارةً وتفند دعايات الكراهية القديمة. كما أن دعم الإنتاج الفني والسينمائي الذي يظهر صورة المسلم والعربي الحقيقية بات ضرورياً لمنافسة الصورة المشوهة الموروثة من أفلام هوليوود. كذلك ينبغي توفير المنح وتشجيع الطلاب والنخب الغربية على زيارة بلداننا ومعايشة ثقافتنا عن قرب لإزالة الحواجز النفسية. إنها عملية بناء جسور طويلة الأمد، لكنها تستحق الجهد لأنها الضمان لترسيخ فهم أفضل وعدالة أطول مدى لقضايانا.
- توحيد الصف الداخلي ونبذ خطاب الكراهية المحلي: أخيراً، ربما يكون من المحرج أن نقول إن العالم يتغير لصالحنا بينما لا نزال نعاني داخلياً من انقسامات وكراهية بين بعضنا البعض. فإذا كنا نطالب الآخرين بأن لا يخافوا منا أو يكرهونا ظلماً، فالأجدر بنا نحن أن نقتلع أية نوازع طائفية أو عصبية بين مجتمعاتنا. وحدة الصف الإسلامي والعربي هي صمام الأمان الأقوى في مواجهة التحديات الخارجية. ولا يمكن أن نكسب تعاطف العالم إن كنا نفشل في تعاطف بعضنا مع بعض. ولنتذكر أن مشروع الصهيونية قام أصلاً على مبدأ “فرق تسد”؛ سواء بتأجيج الحروب الأهلية بين العرب أو بإثارة صراعات سنية-شيعية وغيرها.
إفشال هذه المخططات يبدأ من تعزيز خطاب الوحدة والتسامح داخل بلداننا، والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة (الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك) بدل نبش خلافات الماضي. وبهذا نقوي مناعتنا الداخلية ونكون أكثر استعداداً لاستثمار الفرص الخارجية.
في الختام، يُمكن القول إن القضية الفلسطينية – التي مرت بمراحل عدة خلال قرن من الزمن – تدخل الآن مرحلة عالمية فارقة. فبعد مرحلة النشوء، ثم مرحلة التأييد العربي، ثم مرحلة التعاطف الإسلامي، وصولاً لمرحلة التعاطف الإنساني الأممي – ها نحن نشهد تشكّل إجماع شعبي دولي على رفض الظلم الواقع على الفلسطينيين والمطالبة بكبح جماح إسرائيل. هذه اللحظة لم تأتِ من فراغ؛ بل هي ثمرة نضال وصمود أسطوري للشعب الفلسطيني أولاً، وصحوة ضمير في العالم ثانياً. وإذا كان التاريخ يعلمنا درساً، فهو أن استثمار اللحظات التاريخية هو ما يصنع الفارق. لدينا اليوم فرصة تاريخية لتصحيح البوصلة واستعادة زمام المبادرة. فإن كانت فوبيا الإسلام قد تصدّعت في عقر دار صانعيها، فعلينا نحن أهل الإسلام ألا نسمح بترميمها مجدداً، بل نعمل على إنهائها تماماً عبر نشر ثقافة الحوار والتعايش من جهة، وفضح عنصرية المشروع الصهيوني من جهة أخرى حتى يسقط القناع عن وجهه كاملاً أمام العالم أجمع.
وكما نجح زهران ممداني في إسقاط جدار الخوف داخل نيويورك، نستطيع نحن الشعوب والقيادات العربية والإسلامية – إن خلصت النوايا وتوحدت الجهود – أن نسقط جدران الفصل والهيمنة واحداً تلو الآخر، ونفتح صفحة جديدة يكون فيها العدل والسلام والاحترام المتبادل هي القيم التي تحكم العلاقات الدولية، لا خطاب الكراهية ولا منطق القوة الغاشمة.